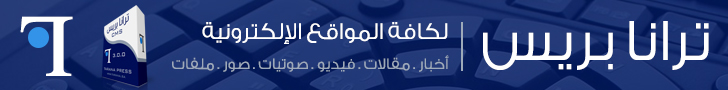جدة : كتب إبراهيم محمد الدوي
ليس من الصعب أن نكتشف معادن الناس، فالحياة كفيلة بذلك، لكن الأصعب أن نقبل الحقيقة حين تظهر عارية بلا زينة.
وفي مشاهد الأفراح – حيث تكثر الابتسامات وتزدحم القاعات – تتجلى تلك الحقيقة بأوضح صورها.
عرفتُ رجلاً من أنقى الناس سريرةً، ومن أكرمهم يدًا، يشهد له القاصي قبل الداني، لا لأن صوته عالٍ، بل لأن أثره عميق. حين زوّج أحد أبنائه في حياته، كان المشهد مهيبًا: حضور غفير، وعدسات، وموائد، ووجوه تتسابق إلى الصفوف الأولى. كثير منهم لم يأتوا حبًّا فيه، بل طمعًا فيما خلفه؛ مصالح، صورة، أو موطئ قدم في مجلسه العامر.
ثم مضت الأعوام، وغاب الرجل إلى رحمة الله.
وبعد ست سنوات، تزوّج أحد أبنائه.
هدأ المشهد، خفت الضجيج، وغابت الكاميرات.
لم يحضر إلا القريبون، والأصدقاء الصادقون، وأولئك الذين يعرفون قيمة الإنسان لا قيمة ما وراءه.
وهنا فقط… ظهر الفرق.
ليس الفرق في الكراسي، ولا في عدد الحضور، بل في النية.
من حضر في حياته كان كثيرٌ منهم يرى في الرجل منفعة،
ومن حضر بعد موته رأى فيه قيمة.
ثم تكرّر المشهد مع رجل آخر يشبهه في كرمه ونبله، لكنه لا يزال حيًّا.
ازدحمت القاعة مرة أخرى، وارتفعت الهدايا، وتسابقت المجاملات، وعاد الزخم الإعلامي وكأن التاريخ يعيد نفسه.
فهمت حينها أن القضية ليست في الأشخاص، بل في ميزان الناس.
كثيرون لا يقيسون الإنسان بما هو عليه،
بل بما يمكن أن يمنحه لهم.
فإذا كان حيًّا، تُفتح الأبواب،
وإذا غاب، أُغلقت القلوب.
إنها معايير مزدوجة،
تُكرّم الحيّ ما دام نافعًا،
وتنسى الميت لأنه لم يعد يُرجى منه شيء.
لكن في هذه القسوة عدلٌ خفيّ:
فالموت لا يسرق مكانة الكرام،
بل ينقّيها.
يُبعد الزائفين،
ويُبقي الصادقين.
وما أجمل أن يُشيّع الإنسان بعد موته بقلةٍ تعرفه،
خيرٌ من أن يُحاط في حياته بجموعٍ لا تراه.
والله المستعان،
وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل ٠